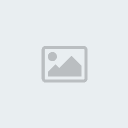الآيتــان
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الْلاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتكم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتي في حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحلائِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ كِتَـبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـآتوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً}(23ـ24).
معاني المفردات
{وَرَبَائِبُكُمُ}: بنات نسائكم من غيركم، جمع ربيبة، وهي بنت زوجة الرجل من غيره، سمّيت بذلك لتربيته إياها، وتسمّى كذلك سواء تولّى تربيتها أم لم يتولَّ ذلك، وسواء كانت في حجره أم لم تكن لأنه إذا تزوج بأمها فهو رابّها وهي ربيبته، ولهذا فإن القيد المذكور {اللاتي فِى حُجُورِكُمْ} قيد توضيحي مبني على الغالب، لا احترازيّ.
{حُجُورِكُمْ}: ضمانكم وتربيتكم، يقال: فلان في حجر فلان أي في تربيته.
{وَحَلائِلُ}: الزوجات؛ جمع حليلة: وهي الزوجة، مشتقة من الحلال. قال الطبرسي: والذكر حليل وجمعه أحلّة.
{وَالْمُحْصَنَاتُ}: المتزوجات، لأنهن أُحصنّ بالأزواج. والإحصان: المنع، وقد تطلق المحصنات على العفيفات لامتناعهن عن الفجور، وحفظهن أنفسهن، والمقصود في الآية المعنى الأول.
{مُّحْصِنِينَ}: أعفّة، تقصرون أنفسكم على ما أحلّ الله، فالمراد بإحصان العفة ما يقابل السفاح، وليس الاحتراز عن الزواج.
{مُسَافِحِينَ}: زناة، والسفاح الزنى، وأصله من السفح، وهو صبّ الماء، وجمع مسافح مسافحون، وجمع مسافحة مسافحات {مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} [النساء:25].
{اسْتَمْتَعْتُمْ}: أي تلذذتم وانتفعتم، والمراد به ـ كما عن ابن عباس وأبي سعيد والسّدي وجماعة من التابعين ـ زواج المتعة، وهو الزواج المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم.
يقول الطبرسي: «لفظ الاستمتاع والتمتّع وإن كان في الأصل واقعاً على الانتفاع والالتذاذ، فقد صار بعرف الشرع مخصوصاً بهذا العقد المعيّن، لا سيّما إذا أضيف إلى النساء»[1].
* * *
المحارم في الإسلام
وهذا تشريع إسلامي يتناول المحارم من النساء اللاتي حرّم الله على الرجال الزواج بهنّ، من خلال علاقات النسب والرضاع والزواج... وربما كان، في هذا اللون من التشريع، تخطيطٌ لنظام الأسرة في إيجاد مساحة واسعة من العلاقات الإنسانية بين الرجال والنساء، التي يعيش فيها المجتمع المشاعر الطاهرة التي لا تتحرك من أيَّ إحساس جنسيٍّ، نتيجة ما يثيره التحريم من حواجز نفسية ضد ذلك الإحساس، مما يفسح المجال لحرية الاختلاط بعيداً عن المشاكل السلبية التي قد تحدث من خلاله في بقاء الرجال والنساء في حالة اختلاط... وبذلك يمكن للأسرة الصغيرة داخل البيت، وللأسرة الكبيرة داخل العائلة، أن تحافظ على توازن العلاقات في الحياة اليومية بشكل لا يثير أية مشكلةٍ أخلاقيةٍ. وقد نستطيع اعتبار مثل هذه الحواجز النفسية وسيلةً عملية من وسائل التربية الإسلامية التي يراد من خلالها تركيز المناعة الأخلاقية في بعض العلاقات القريبة الحميمة، من خلال ما يوحيه للذات من مشاعر وأحاسيس تتصل بالعمق الداخلي من حركة الشخصية الإنسانية، ليتعلّم كيف يقف عند حدود الله من خلال جذور البناء المتماسك للذات المرتكز على الإيمان، كما يقف عند حدوده في التوجيهات العامة الاتية من أوامر الله ونواهيه، بعيداً عن الجوانب الذاتية الداخليّة.
ولا بد للتربية الإسلامية من الانطلاق في الاتجاه الذي يعمل على إثارة التشريع كعقدةٍ متأصلةٍ في الذات، لا سيّما في مثل هذه العلاقات المتصلة بالجانب الجنسي من حياة الإنسان، لينطلق الالتزام كحاجزٍ نفسيٍّ يحول بين الإنسان وبين الإقدام على الانحراف، لأن ذلك هو الذي يحمي للتشريع قوته في حركة الإنسان العمليّة.
وقد حاول دعاة الانحراف والضلال مواجهة ذلك بإثارة الأجواء التي تخفف من حالة الرفض النفسي للعلاقات المحرّمة، فبدأت بالقصص والأفلام والأبحاث التي تحاول أن تجعل منها شيئاً طبيعياً في حياة الإنسان، وتعمل على إرجاع الاستنكار إلى تقاليد وعادات قديمة، لا ترتكز على أساس ثابت في عمق المصلحة الإنسانية. وقد ساعدت هذه الأجواء في تحطيم كثير من الحواجز النفسية التي تمنع الأب من إقامة علاقة مع ابنته، أو تنكر على الأخ إقامة علاقة مع أخته، وبدأنا نقرأ في صفحات الجرائد والمجلات أخبار الجرائم من هذه القضايا الأخلاقية المنحرفة التي اعتبرت لوناً من ألوان الحرية الجنسية.
وقد نحتاج في مواجهة ذلك إلى التحرّك على أكثر من صعيد، من أجل تطويق هذه الحملة والعودة بالإنسان إلى حالة الالتزام العملي بهذه الحدود الأخلاقية، على أساسٍ من حركة الدين والأخلاق في فكر الإنسان وضميره، كجزءٍ من مواجهة المفاهيم المنحرفة التي تعمل على تحويل المسيرة الإنسانية في غير الخط السليم.
وقد اعتبر الإسلام علاقة الرضاع من العلاقات المحرمة؛ فإذا تحقق الرضاع ضمن شروطه الشرعية المذكورة في كتب الفقه، فإنه يحقّق، في نطاق العلاقات، وجهاً من وجوه التحريم، في ما يفرضه من عنوان الأم والأخت والبنت وغيرها من العناوين اللاحقة لذلك… وقد تحدّثت الآيات عن الأم والأخت الرضاعيتين، ولكن الاقتصار عليهما لا يعني انحصار التحريم فيهما، لأن أيَّ عنوان من هذه العناوين يفرض حدوث العناوين الآخرى التابعة لها بشكل طبيعيٍّ. وقد جاءت السنة المطهرة، لتعطي الموضوع حجم القاعدة في الحديث النبوي المأثور: «إن الله حرّم من الرضاعة ما حرم من النسب»[2].
* * *
أما العلاقات المحرَّمة الناشئة من علاقات الزواج، فقد تحدثت الآية عن بنت الزوجة التي يطلق عليها اسم الربيبة، بشرط أن تكون الزوجة مدخولاً بها؛ أما إذا لم تكن كذلك، فلا تحريم إلا من حيث الجمع بين الأم وابنتها، فإذا طلّق الأم كان له الحق في زواج البنت. وقد ذكر الفقهاء والمفسرون أنه لا يشترط كون البنت في حجر الزوج في التحريم، بل اعتبر القيد وارداً مورد الغالب، لا مورد التحديد؛ وعن أم الزوجة بشكل مطلق؛ وعن زوجة الابن النسبي والرضاعي، وعن أخت الزوجة جمعاً لا عيناً، فلا يجوز له الجمع بين الأختين، ولا مانع من الزواج بإحداهما إذا طلّق الأخرى. وقد استثنى القرآن الحالات السابقة على التشريع، فأقرّها في قوله {إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}. وقد ذكر الفقهاء: أن ولد الولد وولد البنت، في امتداد السلسلة، يتساويان مع الولد في حرمة الزوجة على الجد، لصدق العنوان عليه.
وقد تحدثت الآيات عن تحريم المحصنات من النساء المتزوّجات، فلا يجوز التزوج بهنّ؛ وبهذا أغلق الإسلام الباب في موضوع تعدد الأزواج للمرأة الواحدة، انطلاقاً من التخطيط الإسلامي للأسرة في اعتبار الرجل هو الأساس في النسب وفي إدارة شؤون الأسرة، بالإضافة إلى ما ألمحنا إليه سابقاً من عدم وجود أسباب ضرورية في موضوع تعدد الأزواج، كما هو الحال في تعدد الزوجات.
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}، فلا يجوز لكم الزواج بهن، ومنهن الجدات للأم وللأب. {وَبَنَاتُكُمْ} وتشمل الكلمة بنات البنات والأولاد وإن نزلن. {وَأَخَواتُكُمْ} سواء أكنّ للأبوين أم لأحدهما، ولا مانع من الزواج بأخت الأخ إذا لم تكن أختاً له، وأخت الأخت إذا لم تكن أختاً له، كما إذا كان لأخيك من طرف الأب أو أختك من طرف الأب أو أخت من طرف الأم التي كانت متزوجةً بإنسانٍ آخر غير الأب، فولدت له بنتاً ثم ولدت الأخ من الأب. {وَعَمَّاتُكُمْ} والعمة هي كل أنثى أخت لرجل يرجع نسبك إليه بالولادة مباشرة أو بالواسطة، فتصدق على أخت الأب وأخت الجد، وعلى ضوء هذا تحرم عمة الأم، لأنها أخت لجدك من أمك. {وَخَالاتُكُمْ} الخالة هي كل أنثى أخت لمن يرجع نسبك إليها بالولادة مباشرة أو بالواسطة، فتشمل أخت أمك وأخت جدتك وخالة أبيك {وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأخْتِ} وتمتد إلى بنات أولادهما وبناتهما في السلسلة في خط النزول {وَأُمَّهَاتُكُمُ الْلاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} بالشروط المعتبرة في تحريم الرضاع الذي ورد الحديث النبوي الشريف فيه الذي عمل به الجميع: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وعلى هذا، فإن أيّ عنوان نسبيّ ينطبق على عنوان رضاعي، يؤدي إلى التحريم، فكل امرأة حرمت من الرضاع تحرم مثلها من الرضاع، سواء أكانت أمّاً أم أختاً أم بنتاً أم عمة أم خالة أم بنت أخ أم بنت أخت، وإذا كان القرآن لم يتحدث إلاّ عن الأم والأخت من الرضاعة، فإن الباقي يفهم من طبيعة المبدأ واقتضاء الأمومة والأبوّة واقتضائهما العمومة والخؤولة، واقتضاء الأخوّة عنوان ابنة الأخ والأخت، وهكذا...
وربما كان الأساس في سرّ تحريم الرضاع للزواج هو أن نبات لحم الرضيع واشتداد عظمه بلبن الأم يجعله كأولادها من حيث إنه جزء من بدنها، لأن نموّه كان من خلال عناصرها الجسدية في غذائه، كما هو جزء من بدنها. {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ} فإن أم الزوجة تحرم على الزوج، سواء أكانت أمّاً بشكل مباشر كالأم، أو بالواسطة كالجدة، من دون فرق بين الدخول بالزوجة وعدمها، وهناك قول نادر باشتراط الدخول بالزوجة في حرمة أمها.
{وَرَبَائِبُكُمُ اللاتي فِى حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} وبهذا لم تحرم الربيبة على زوج الأم في حالة عدم الدخول بالأم، فيجوز له الزواج بها بعد طلاق الأم، ولكن لا يجوز الجمع بينهما، أما قيد {اللاتي فِى حُجُورِكُمْ} فقد أشرنا أنه ليس وارداً على نحو الشرطية، بل على نحو الفرد الغالب، لأن الغالب أن تكون البنت في حجر أمها لحاجتها إليها في الحضانة والرعاية. وفي ضوء ذلك تثبت الحرمة في صورة عدم كونها في حجرها. وربما كان هذا القيد إشارة إلى أن الربائب تشارك سائر الأصناف من الاشتمال على ملاك التحريم وحكمته، وهو الاختلاط الواقع المستقر بين الرجل وسائر الأصناف من النساء والمصاحبة الغالبة بين هؤلاء في المنازل والبيوت، «فلولا حكم الحرمة المؤبدة، لم يمكن الاحتراز من وقوع الفحشاء بمجرد تحريم الزنى»[3] ـ كما يقول صاحب الميزان.
{وَحَلائِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصلابِكُمْ} فلا تحل زوجة الابن النسبي لأبيه، ولا يشمل ذلك ولد التبنيّ، أمّا الولد الرضاعي، فحكمه في ذلك حكم الولد النسبي انطلاقاً من الحديث المأثور: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، فتحرم زوجته على أبيه الرضاعي، ويلحق بالابن ابن الابن إلى آخر السلسلة.
{وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}، فلا يجوز الزواج بأخت زوجته ما دامت زوجته معه أو كانت في عدة الطلاق الرجعي، فإذا فارق زوجته وانتهت عدتها الرجعية، جاز له الزواج بأختها بعد ذلك، وإذا طلقها طلاقاً بائناً، جاز له الزواج بأختها في أثناء العدة البائنة. وربما كان الأساس في حرمة الجمع بين الأختين، هو أن الانتماء إلى زوج واحد، يخلق بينهما ـ غالباً ـ الكثير من التنافس عليه، كما في سائر الضرائر، مما يؤدي إلى التنافر والتضاد الشعوري الذي يحطم العلاقة الأخوية المبنية على المودة والمحبة ويحوّلها إلى حالة من الصراع المرير المستمر الذي ينطوي على مشاكل كثيرة وتعقيدات صعبة.
أما قوله {إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} فهو جار على غرار قوله: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}. فقد كانوا في الجاهلية يجيزون ذلك، فيجمعون بين الأختين، فكانت الآية تمثل الحكم بالعفو عنه من حيث شرعية النتائج الناتجة عن العلاقة الزوجية السابقة من انتساب الأولاد شرعاً إلى آبائهم وأمهاتهم وإجراء أحكام القرابة عليهم كأية ولادة شرعية، ولكنها لا تثبت الاستمرار في شرعيته إذا كان باقياً في زمن نزول الآية.
فقد ورد في اسباب النزول أن النبي(ص) فرق بين الأبناء وبين نساء آبائهم مع كون النكاح قبل نزول الآية[4] وقد احتمل صاحب تفسير الميزان أن يكون قوله تعالى: {إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} راجعاً إلى جميع الفقرات المذكورة في الآية من غير أن يختص بقوله {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ}، فإن العرب وإن كانت لا ترتكب من هذه المحرمات إلا الجمع بين الأختين، ولم تكن تقترف نكاح الأمهات والبنات وسائر ما ذكر في الآية، إلا أن هناك أمماً كانت تنكح أقسام المحارم، كالفرس والروم وسائر الأمم المتمدنة وغير المتمدنة يوم نزول الآيات على اختلافهم فيه، والإسلام يعتبر صحّة نكاح الأمم غير المسلمة الدائر بينهم على مذاهبهم، فيحكم بطهارة مولدهم ويعتبر صحة قرابتهم بعد الدخول في دين الحق هذا لكن الوجه الأول أظهر[5] .
{إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} فإن الإسلام يجب ما قبله، فلا مسؤولية على المسلم الذي كان يمارس الانحراف عن خط الشريعة قبل إسلامه.
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ} من الإحصان وهو المنع، يقال: أحصنت المرأة نفسها إذا عفّت فحفظت نفسها وامتنعت عن الفجور، قال تعالى: {الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} [التحريم:13]. أي عفّت، ويقال: أحصنت المرأة ـ بالبناء للفاعل والمفعول ـ إذا تزوجت، فأحصن زوجها أو التزوج إياها من غير زوجها، وهذا هو المراد من الآية ـ على الظاهر ـ لا ما قيل من أن المراد من إحصان المرأة كونها حرّة، مما يمنعها من أن يمتلك الغير بضعها، أو منعها ذلك من الزنى، لأن ذلك كان فاشياً في الإماء ـ كما يقولون ـ وهكذا تكون الفقرة واردة للمنع من زواج المتزوجات من أشخاص آخرين، سواء أكانت المرأة عفيفة أم غير عفيفة، أو كانت حرةً أم مملوكةً، لأن الزواج المتعدد، ليس مشروعاً بالنسبة إلى المرأة، بل تقتصر شرعيته على الرجل.
{إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ}، وقد استثنى القرآن من المحصنات ملك اليمين؛ إذا كانت الأمة متزوجة، ووقعت في الأسر في حرب المسلمين والمشركين، أو أراد سيّدها أن يسترجعها بعد الزواج، فيستبرئها وينال منها في ما أفاض فيه الفقهاء في كتب الفقه.
ثم أكدت الآية التحريم بكلمة: {كِتَـبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ}، كأسلوب من أساليب للإيحاء بقوة التشريع، باعتبار أنه مما كتبه الله الذي يملك أمر الإنسان في جميع مجالات حياته العمليّة.
{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} لم يربط القرآن التحليل بعنوان معين، بل أطلقه في النطاق الخارج عن العناوين المحرّمة، ولكن ضمن شروط معينة، منها دفع المهر، على أساس الأسباب الشرعية التي جعلها الشارع أساساً لشرعية العلاقات كالعقود ونحوها، مما يكون فاصلاً بين العفة ـ الزواج وما يلحق به من الطرق المشروعة الذي عبرت عنه الآيات بالإحصان ـ وبين السفاح. وقد ذكر الفقهاء مخصصات لهذا العموم، في ما جاءت به السنّة المطهّرة من بعض العوارض الطارئة التي يمكن أن توجب التحريم في بعض الحالات، مما هو مذكور في كتب الفقه.
{أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} وذلك بأن تقدموا أموالكم في إقامة العلاقة بينكم وبين النساء اللاتي أحلهن الله لكم على أساس النكاح الشرعي لا على أساس الزنى والسفاح، فإن ذلك هو السبيل الوحيد الذي رخص الله فيه في علاقة الرجل بالمرأة، فلا إطلاق في الحلّية أن يمارس الرجل والمرأة في الجانب الجنسي بدون عقد، لأن الممارسة لن تكون شرعية في الإسلام.
* * *
الآية وزواج المتعة
{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} هذا تفريع على ما تقدّم، وتقرير للفكرة التي تدخل إلى عمق المعنى الذي يوحيه المهر، من خلال ما يرمز إليه من اعتباره لوناً من ألوان التعويض بمحبة عما يحصل عليه الزوج من الاستمتاع؛ بالإضافة إلى المعاني الآخرى التي يريدها الله للزواج، من حيث كونه مرتكزاً على المودّة والرحمة والوحدة الروحية بين الزوجين... وقد انطلق القرآن في إعطاء ذلك طابعاً روحياً، عندما اعتبره فريضة من الله، على خلاف الكلمات غير الدقيقة التي تحتقر جانب الاستمتاع في الزواج وترى فيه إهداراً لكرامة المرأة، لأنه يمثل نوعاً من البيع والشراء ونحوهما من المعاني التي لا تقترب من احترام إنسانية المرأة... ولكن الإسلام يريد من الإنسان أن ينظر إلى الزواج نظرة واقعية تضع كل الأشياء الحسية والمعنوية في نطاقها الطبيعي المعقول، فلا تغفل أي جانب من الجوانب الطبيعية، التي يتمثل فيها الجانب الجنسي كشيء بارز كبير، ليكون المفتاح الذي يفتح للزوجين الأبواب الآخرى للزواج؛ وبهذا لم تكن النظرة إليه سوداء، بل كانت بيضاء واضحة تتحرك في النور، في كل ما يثار حوله من أحاديث. وليس ذلك إلا لأن الإسلام يريد من الإنسان أن يتعاطى مع غرائزه وشهواته وتطلعاته كموجود حي يعيش على الأرض، كما هو في تكوينه الذاتي؛ فإذا أراد أن يرتفع به، فإنه يعمل على ذلك من خلال إنسانيته بكل ما تتطلبه من معطيات، وما تفرضه من حاجات، وما تنطلق فيه من تطلعات روحية ومادية؛ فهو لا يريده ملاكاً، بل يريده إنساناً يعيش في ماديته بعضاً من وحي الملاك.
وهكذا أراد القرآن أن يسمي الأشياء بأسمائها، فهناك استمتاع، وهناك أجر على ذلك، ولكنه قد يختلف في معطياته عن معنى الأجر في غيره من الأشياء والأعمال.
هذا بعض ما نستوحيه من هذه الفقرة، في ما تتضمنه من التعبير. ولكن المفسرين لم يتوقفوا عند ذلك، بل دخلوا في مجالات أخرى، فتساءلوا هل هذه الفقرة مجرّد تأكيد لمعنى المهر ووجوب دفعه؟ أو هي بيان لزواج من نوع آخر عرفه المسلمون في عصر الدعوة ثم اختلفوا بعد ذلك في حليته وحرمته، وهو «زواج المتعة» الذي هو الزواج إلى أجل مسمى ضمن شروط معينة، تلتقي مع الزواج الدائم في بعضها وتختلف عنه في بعضها الآخر؟!
المعروف بين المفسرين من علماء الشيعة وبعض علماء السنة، أن المقصود بها زواج المتعة، وقد أوضح ذلك صاحب تفسير الميزان العلاّمة الطباطبائي، فقال:
«والمراد بالاستمتاع المذكور في الآية نكاح المتعة بلا شك؛ فإن الآية مدنيّة نازلة في سورة النساء في النصف الأول من عهد النبي(ص) بعد الهجرة، على ما يشهد به معظم آياتها؛ وهذا النكاح ـ أعني نكاح المتعة ـ كانت دائرة بينهم معمولة عندهم في هذه البرهة من الزمان من غير شك ـ وقد أطبقت الأخبار على تسلّم ذلك ـ سواء كان الإسلام هو المشرّع لذلك، أو لم يكن، فأصل وجوده بينهم بمرأى من النبي ومسمعٍ منه لا شك فيه؛ وكان اسمه هذا الاسم ولا يعبّر عنه إلا بهذا اللفظ، فلا مناص من كون قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} محمولاً عليه مفهوماً منه هذا المعنى.
كما أن سائر السنن والعادات والرسوم الدائرة بينهم في عهد النزول بأسمائها المعروفة المعهودة، كلما نزلت آية متعرضة لحكم متعلق بشيء من تلك الأسماء بإِمضاء أو ردٍّ أو أمر أو نهي، لم يكن بدٌّ من حمل الأسماء الواردة فيها على معانيها المسماة بها، من غير أن تحمل على معانيها اللغوية الأصلية، وذلك كالحج والبيع والربا والربح والغنيمة وسائر ما هو من هذا القبيل... فلم يمكن لأحد أن يدّعي أن المراد بحج البيت قصده، وهكذا... وكذلك ما أتى به النبي(ص) من الموضوعات الشرعية، ثم شاع الاستعمال حتى عرفت بأساميها الشرعية، كالصلاة والصوم والزكاة وحج التمتع وغير ذلك، لا مجال بعد تحقق التسمية لحمل ألفاظها الواقعة في القرآن الكريم على معانيها اللغوية الأصلية بعد تحقق الحقيقة الشرعية أو المتشرعة فيها. فمن المتعين أن يحمل الاستمتاع المذكور في الآية على نكاح المتعة لدورانه بهذا الاسم عندهم يوم نزول الآية، سواء قلنا بنسخ نكاح المتعة بعد ذلك بكتاب أو سنّة أو لم نقل؛ فإنما هو أمر آخر.
وجملة الأمر، أن المفهوم من الآية حكم نكاح المتعة، وهو المنقول عن القدماء من مفسري الصحابة والتابعين، كابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة ومجاهد والسدي وابن جبير والحسن وغيرهم؛ وهو مذهب أئمة أهل البيت(ع).
ومنه يظهر فساد ما ذكره بعضهم في تفسير الآية، أن المراد بالاستمتاع هو النكاح؛ فإن إيجاد علقة النكاح طلب للتمتع منها، هذا وربما ذكر بعضهم أن السين والتاء في «استمتعتم للتأكيد»، والمعني: تمتعتم، وذلك لأن تداول نكاح المتعة (بهذا الاسم) ومعروفيته بينهم لا يدع مجالاً لخطور هذا المعنى اللغوي لذهن المستمعين»[6].
وهكذا نجد في هذا الاتجاه، في تفسير هذه الفقرة من الآية، ارتكازاً على الكلمة ـ المصطلح «الاستمتاع»، من خلال ما توحيه كلمة «زواج المتعة» في مفهوم الصحابة آنذاك الذي تنقله الروايات التي تحدثت عن هذا النوع من الزواج، وما فهمه منه المفسرون من الصحابة وغيرهم، ولا سيما ما جاءت به القراءة المروية: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى»، مما يعيّن هذا المعنى؛ فإن هذه الكلمة إذا لم تكن جزءاً من النص، فإنها تعتبر تفسيراً له. وهذا ما يجعل القوة في جانب هذا التفسير، إذا كان الأمر دائراً بين المعنيين بحسب طبيعة النص في ذاته.
* * *
الخلاف الإسلامي في زواج المتعة
وقد اختلف المسلمون من المفسرين والفقهاء في هذا الزواج، بين قائل بأن الإسلام قد شرَّعه، من خلال هذه الآية أو غيرها، في فترة من الزمان، ثم حرّمه بعد ذلك، كما هو الحال في كثير من الأحكام الشرعية التي يعرض عليها النسخ، وبين قائل بأنه لا يزال مباحاً كما كان، لأن التشريع قد ثبت بإجماع المسلمين في فترةٍ من فترات التشريع، ولم يثبت لنا النسخ، لأن الآيات التي ذكرت في هذا المجال لا تصلح للنسخ، إما من جهة عدم منافاتها لهذه الآية، لأن نسبتها إليها نسبة الخاص إلى العام، مما يجعل الموضوع في نطاق تخصيص العام، لا في نطاق نسخ العام للخاص؛ وإما من جهة تأخر هذه الآية، المدعى كونها منسوخة، عن الآيات التي اعتبرت ناسخة، مما لا يترك مجالاً لتوهم نسخ المتقدم للمتأخر. أما الأخبار التي ادعي كونها ناسخة، فقد يناقش بإسنادها أولاً، وباضطرابها ثانياً، لأنها تختلف في تاريخ التحريم، وبأنها أخبار أحاد ثالثاً. ولا بد في ثبوت النسخ، لا سيما نسخ القرآن بالخبر المتواتر. وقد استفاضت الأخبار بأن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب هو الذي نهى عنها، من دون أن ينسب التحريم إلى الرسول(ص)، مما يدل على أنه من التوجيهات الإدارية التي كان يصدرها، انطلاقاً من اجتهاده الخاص، مما لا يكون ملزماً للمسلمين في السير عليه من ناحية شرعية بعد أن كان ثابتاً بأصل الشريعة؛ ولهذا رأينا بعض كبار المسلمين من الصحابة وغيرهم من قبله ومن بعده، يمارسون هذا الزواج ويفتون به، من دون أن يجدوا حرجاً في ذلك.
وقد أجمع أئمة أهل البيت(ع) على استمرار إباحته، وتشجيع أتباعهم على ممارسته من أجل بقاء هذه السنّة حيّة في حياة الأمة؛ وقد روى الكثيرون من الثقاة قول الإمام علي(ع) «لولا ما فعل عمر بن الخطّاب في المتعة ما زنى إلا شفا»[7] أي إلا قليل من الناس؛ وروي: «إلا شقي».
وقد وقع الخلاف بين المسلمين من علماء السنّة وعلماء الشيعة في أمر هذا الزواج من ناحية فقهية وتفسيرية، مما حفلت به الكتب الموسعة من التفاسير وكتب الفقه. وقد أجملنا الفكرة العامة للخلاف من خلال ما قدمناه من حديث، ونترك للقارىء أن يرجع إلى ما كتبه العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان، والعلامة العسكري في مقدمة كتاب «مرآة العقول» وغيرهما من الأعلام الذين تحدثوا عن هذا الزواج في كتب مستقلة.
المتعة في الجانب الاجتماعي للمشكلة الجنسية
وقد نلاحظ في هذا المجال، أن المسألة قد تحتاج إلى دراسة من ناحية أخرى، وهي أن المبررات التي ذكرها بعض الباحثين لتشريع هذا الزواج، في بعض الحالات الطارئة في عصر الرسالة، لا تزال تفرض نفسها على الواقع الذي يحتضن أوضاعاً وحالات كثيرة، قد تزيد في صعوباتها عن تلك الحالات. فإذا كان ذلك هو المبرر للتشريع في نظر هؤلاء، فلا بد من أن يبقى الحكم مستمراً باستمرار مبرّره، مما يجعل من موضوع النسخ أمراً غير واضح في ملاكاته. ونحن نعرف أن النسخ يعني ـ في مفهومه العلمي ـ انتهاء أمد الحكم الأول بانتهاء أمد المصلحة التي ساهمت في وجوده، وحدوث مصلحةٍ أخرى في الاتجاه المعاكس من أجل حكم آخر مخالف.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الإسلام ينطلق في تشريعه للأحكام الشرعية من منطلق واقعي، في ما يواجهه الإنسان من مشاكل، لتكون الحلول الموضوعة له في حجم تلك المشاكل، لئلا يحتاج الإنسان إلى الوقوع في قبضة الانحراف، أو إلى البحث عن الحلول العملية لدى مبادىء أخرى. وعلى ضوء ذلك، يمكننا أن نلاحظ كيف يسير الزنى جنباً إلى جنب مع الزواج الدائم، في كل مراحل التاريخ في جميع بلدان الأرض، مما يوحي بوجوده كظاهرة إنسانية مستمرة. وقد لا نستطيع تفسيره دائماً بأنه يمثل الرغبة في الانحراف والتمرد على الشرعية والقانون، بل ربما كان من الراجح تفسير ذلك بأن الزواج الدائم لا يمثل الحل الشامل الكامل للمشكلة الجنسية، مما يفرض تشريعاً آخر يكمل الحلّ ويلغي الحاجة إلى الانحراف؛ وهذا هو ما نستوحيه من الكلمة المأثورة عن الإمام علي(ع) «لولا ما نهى عنه عمر من أمر المتعة ما زنى إلا شفا»، لأن هذا الزواج يواجه الحالات التي يحاول الإنسان فيها أن يلجأ إلى الزنى، هرباً من قيود الزواج الدائم.
ونحن لا نريد أن نعتبر مثل هذه الملاحظات أساساً فقهياً، لإثبات هذا الحكم الشرعي في مواجهة المنكرين له، لأننا نعرف جيداً أن الأحكام الشرعية خاضعة في إثباتها ونفيها للمصادر التشريعية الأساسية من الكتاب والسنة؛ بل كل ما نريد أن نقوله، إنها تستطيع أن تعطي الوجه الإيجابي للرأي الذي يقدّم الإثباتات الشرعية لهذا الحكم، ليكون ذلك مؤيداً لما ثبت بالدليل لا دليلاً عليه؛ والله العالم بحقائق أحكامه.
* * *
{وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً}. إن المسلمين يخضعون لالتزاماتهم الشرعية في ما يتعاقدون به من عقود، انطلاقاً من أن الوفاء بالعقود هو سمة الإنسان المؤمن، ولكن ذلك لا يمنعهم من أن يتفقوا على أشياء أخرى في غير الحدود المتفق عليها من زيادةٍ ونقصان، لأن ذلك يمثل تنازل صاحب الحق عن حقه برضاه؛ وفي ذلك تأكيد للالتزام، لا انحراف عنه، وهذا ما عالجته هذه الفقرة من الآية، حيث أتاحت للمؤمنين المتعاقدين في عقود الزواج أن يتراضوا في ما بينهم بما يشاؤون من بعد الفريضة؛ فقد يزيدون عليه، وقد ينقصون منه،